
إسلام أبوالعز
تشهد العلاقات بين مصر وفرنسا طفرة غير مسبوقة على مستويات متعددة ذات أبعاد استراتيجية، والتي تتفوق حتى على معايير ومجريات علاقات ثنائية متميزة بين أي من دول القارة الأوربية ودول المنطقة؛ حيث تجاوز هذه الطفرة في العلاقات بين البلدين، خلال السنوات الأخيرة، مسألة تطويرها وتدويرها طبقاً لتطورات إقليمية ودولية تقاطعت فيها مصالح باريس والقاهرة مثل غاز شرق المتوسط، لمستوى جديد يتمثل في شراكة استراتيجية لا تقتصر فقط على جوانب اقتصادية وسياسية ودبلوماسية معتادة، بل تحركات محورية على صعيد المنطقة والقارة الافريقية.
وتلخص 6 زيارات للسيسي منذ توليه الحكم لباريس كيف أن الأخيرة تمثل الشريك الأوربي الأبرز بالنسبة للقاهرة، كذلك الأمر بالنسبة للسياسة الخارجية الفرنسية التي تجعل من القاهرة الشريك الأهم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا؛ لاسيما مع تطور لافت في معادلة العلاقات بين البلدين، والذي يمكن تبسيطه بشكل مُخل بأن مصر تمثل بوابة استعادة فرنسا لدورها وتعزيز نفوذها في المنطقة وأفريقيا في سنوات انكماش أميركي، فيما عوض الدور الفرنسي هذا غياب/رفض واشنطن الاضطلاع بدور يتوافق مع أولويات ومصالح القاهرة وخاصة المرتبطة بأمنها القومي.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، جاءت بداية التلاقي المصري-الفرنسي فيما يخص ليبيا وخاصة في العامين الماضيين، كتطور لبديهية كلاسيكية في العلاقات بين البلدين طيلة عقود مفادها موازنة العلاقات مع واشنطن فيما يخص المنطقة، ولكن مع متغير جديد تمثل في كيفية تطوير هذا التوازن وإدارته وتعظيمه من مجرد حالة طارئة مرتبطة بالأساس بمتغيرات سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، لعلاقات تقاطعيه ذات ادارة متكافئة فيما يخص ملفات مثل الطاقة والامن والشؤون العسكرية وغيرها من الملفات ذات الأبعاد الجيوستراتيجية، ومردودات ذلك على مستوى سياسي ذو ابعاد تتجاوز علاقات ثنائية جيدة بين بلدين بحجم مصر وفرنسا.
يرصد هذا التحليل مراحل تطور العلاقات المصرية الفرنسية خلال السنوات القليلة الماضية، ملقياً الضوء على مرتكزاتها الاستراتيجية والجيوسياسية، وصولاً لدواعيها السياسية على مستويات ثنائية، وكذلك على مختلف الساحات والملفات الإقليمية والدولية، والطفرة الجديدة فيها خاصة المتعلقة بأفريقيا (على مستوى تلاقي مصالح متعدد الاتجاهات في ليبيا والقرن الافريقي)، ومن ثم محاولة القاء ضوء على المستقبل القريب لهذه المفاعيل خاصة في ظل متغيرات وتحولات كبيرة منذ مطلع العام الماضي على مختلف الأصعدة.
القاهرة باريس واشنطن.. ما يتجاوز السلاح
أتت مخرجات وفاعليات مؤتمر باريس الأخير لتؤكد المستوى المرموق الذي وصلت له العلاقات بين البلدين، حيث شكل المؤتمر بخلاف عنوانه الرئيسي، الاستثمار في السودان وإسقاط جزء كبير من ديونه ودور مصر في انفاذه ودلالات ذلك على مستويات إقليمية وافريقية، منصة لإعلان ما يشبه محور إقليمي/دولي ذو مرتكزات جيوسياسية تمتد من جنوب البحر الأحمر وحتى شرق المتوسط وجنوب الصحراء، وهو ما جاء عبر القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون والملك عبدالله على هامش المؤتمر، والتي كان لها الدور الأبرز في التعجيل بتدخل أميركي بإيقاف التصعيد العسكري الأخير في غزة.
يصف الدبلوماسي والخبير الجيوسياسي الفرنسي، ميشيل دوكلوس، تطور العلاقات المصرية الفرنسية في السنوات الأخيرة “بفرصة عوضت 10 سنوات من التخبط” وذلك في إشارة إلى إخفاق رهانات وتوجهات باريس الخارجية وخاصة المتعلقة بالمنطقة منذ عهد نيكولا ساركوزي، والتي استمرت في عهد فرانسوا أولاند الذي شهدت ولايته تغيرات دراماتيكية في الشرق الأوسط منذ 2011، حيث فاقمت مشكلة مزمنة في السياسة الخارجية للإليزية تمثلت دوماً في غياب حامل إقليمي يؤسس من خلاله لعلاقات طويلة الأمد واستراتيجية، وهو ما استمر -حسب دوكلوس- في السنوات الأولى لعهد جو ماكرون، الذي ما لبثت أن تحولت السياسات الخارجية في عهده إلى نمط شراكة وليس تبعية.
وهو ما تميزت به سياسة فرنسا في علاقاتها بدول المنطقة وخاصة مصر؛ حيث أضحت هذه الشراكة ذات أبعاد تجعل من مناسبة مثل مؤتمر باريس الأخير منصة لإعلان تحولات كبير في سياسات مصر الخارجية، بل وتحفيز للإسراع في ضبط علاقة الأخيرة بواشنطن بايدن.
هنا نجد أن هذه النقلة النوعية المؤسسة على مرتكزات استراتيجية وجيوسياسية لم تأتي على مستوى ثنائي فحسب، ولكن بالأساس كتعويض أو مقاربة وسط لغياب تأثير واشنطن وسنوات انكماشها في الشرق الأوسط منذ عهد أوباما، وكذلك سنوات ترامب الاستثنائية، وهو ما لم يتوفر -حسب دوكلوس أيضاً- في علاقة أي دولة أوربية بدول المنطقة، خاصة إذا كانت دولة فاعلة بحجم وتأثير فرنسا وليس بريطانيا مثلاً عشية خروجها من الاتحاد الأوربي؛ فهذا التأثير لم يأتي فقط من كون فرنسا دولة أوربية وازنة تمتلك كثير من أدوات القوى الفاعلة على الساحة الدولية على مختلف المستويات والأصعدة.
ولكن كون ان موقف الإليزية الخارجي في عهد جو ماكرون ينتهج سياسة تعظيم وتطوير علاقات ومن ثم قدرات فرنسا خارج ما يسمى بالدول الفرانكوفونية أو حتى الدول التي كانت تستعمرها فرنسا قديماً شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، حيث تمسكت باريس بنمط تبعية “طفيلي” للتميز عن السير الأوربي تحت جناح واشنطن طيلة سنوات الحرب الباردة، ومن ثم تحول هذا النمط لعبء داخلي/خارجي، وتكلفة ذلك لاسيما الإرث الاستعماري، وهو ما جعل التمايز يتحول ورطة مثلما حدث في سنوات أولاند أو ساركوزي وفضائح حكمه الداخلية والخارجية.
أما في سنوات ماكرون، فإن هناك منهجية فيما يتعلق بسياسة باريس الخارجية عن شراكات تبتعد عن ثنائية الفساد/الاستعمار، وخاصة في مجال فرنسا الحيوي ومحيطها الجيوسياسي وخاصة في شرق المتوسط، وهو ما تلاقى مع رغبة القاهرة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع فرنسا وفق أنماط جديدة متشعبة، وتتلاقى مع تمايز الموقف الفرنسي عن الأوربي والأميركي فيما يخص المصالح الفرنسية المباشرة، وهو ما وفر للقاهرة هوامش متعددة في فترة انتقالية في علاقاتها مع واشنطن، بل والبناء على هذا لتأسيس نمط جديد في السياسة الخارجية المصرية قائم على تعدد وتنوع الشراكات والموازنة بينها، وليست اعتمادية على طرف واحد -واشنطن- كما الحال في سنوات مبارك.
وإن كان المجال هنا لا يتسع لذكر مفاعيل هذه النقلة النوعية في العلاقات المصرية-الفرنسية على كافة الساحات من جنوب البحر الأحمر وحتى شرق المتوسط مروراً بلبنان وسوريا والأردن، فإن الملف الليبي وما اكتنفه من تعقيدات حُلحلت على مدار السنوات بين 2014 و2020 وفق تدرج تقاربت فيه الرؤى بين باريس والقاهرة، يصلح لأن يكون نموذج استرشادي لفهم دوافع هذه النقلة وكذلك مآلاتها وسيناريوهات تعظيمها، خاصة مع ارتباط هذا الملف بقضايا الغاز والهجرة والإرهاب، والأهم هنا هو كيفية استعادة فرنسا لنفوذها في جنوب الصحراء من بوابة القاهرة، التي بدورها طورت هذه الشراكة من مجرد تعويض للغياب الأميركي فيما يخص ليبيا، لمرتكز جديد في سياسات مصر الخارجية وفق محددات جيوسياسية مع شركاء إقليميين وأوربيين مفاده تنويع وتوازن على أرضية مصالح مشتركة تنطلق من محددات أمن مصر القومي.
يمكن رصد محطات الحضور الفرنسي الجاد والفاعل في الملف الليبي بوقائعه السياسية والعسكرية انطلاقاً من تخوف مشترك من انفلات الأطماع الأردوغانية في البحر المتوسط وشمال أفريقيا وما عُرف -تركياً- وقتها بـ”عقيدة الوطن الأزرق”، وهذه المرحلة بين 2015 و2019 تميزت بأن تحركات باريس على الصعيد الليبي اكتفت بعرقلة جموح أنقرة وفق شراكات مؤقتة وخطوات تكتيكية افتقدت للاستمرارية، وذلك خشية التورط في “مستنقع” ليبيا، وذلك وفق أولوية انتخابية في معظم الأحيان تتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية.
تلك المنهجية التي ثبت في أواخر 2018 أنها غير كافية خاصة مع سلسلة إخفاقات ميدانية طيلة 2019 فيما يخص معارك طرابلس، التي انتهت بتدخل تركي مباشر أواخر العام ذاته، ومن ثم استدراك فرنسا للخلل في تقدير مجريات الصراع في ليبيا على مختلف مستوياته السياسية والعسكرية وخاصة التي باتت تمس وتهدد مصالحها في شرق المتوسط وشمال افريقيا وجنوب الصحراء، وذلك عبر دعم التحولات التي هندستها القاهرة بشقها السياسي المتمثل في “إعلان القاهرة” الذي شكلت باريس الحامل الأوربي له، وكذلك العسكري عبر دعم سياسة “الخط الأحمر” المصرية، والتي كان أبرزها غارة الرافال التي استهدفت أنظمة الدفاع الجوي التركية في غرب ليبيا، والتي قيل وقتها أنها انطلقت من قاعدة فرنسية في مالي.
منطلقات جديدة لعلاقات قديمة.. الرافال نموذجاً
شكل السابق ما يمكن وصفه بذروة تفعيل العلاقات من منطلقات استراتيجية جديدة بين القاهرة وباريس، وهو ما قد بُنيَ على تراكم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين منذ 2015 على مختلف الاتجاهات وإن كان أبرزها التعاون العسكري الذي أضاف نقلة نوعية للترسانة البحرية والجوية المصرية، متمثلة في صفقات متتالية حتى العام الجاري لمختلف الأسلحة النوعية وعلى رأسها حاملتي الطائرات ميسترال وفرقطات فريم الشبحية، والأهم طائرات داسو رافال، التي بالنظر إلى دواعي اختيار القاهرة لها نجد أنها أتت وفق مقاربة تجمع بين سد حاجة القوات الجوية المصرية، بالإضافة لمحددات اقتصادية وأيضاً سياسية تتعلق بضبط العلاقات مع واشنطن دون الوصول لحد الصدام، وخاصة في السنوات الأخيرة من حكم إدارة أوباما.
هنا يمكن النظر إلى هذه الصفقات على مدار السنوات القليلة الماضية كنموذج يمكن القياس عليه بالنسبة للتحولات والطفرة في العلاقات بين باريس والقاهرة؛ حيث مثلت صفقة الرافال حل وسط يكثف منطلقات جديدة للعلاقات بين البلدين وعلى نحو استراتيجي يشمل الإقليم ككل وليس كتكتيك طارئ على مستوى ثنائي، خاصة مع مقاربات لسلم أولويات البلدين على صعيد سياساتهم الخارجية وخاصة فيما يتعلق بشرق المتوسط ومحاولات التوسع التركي في شمال أفريقيا.
فبالتدقيق في خلفية وتفاصيل هذه الصفقات المتتالية، وحدها الأدنى المتمثل في تأكيد سياسة التنويع وتعدد المصادر التي ميزت صفقات تسليح الجيش المصري في السنوات الأخيرة دون الاعتماد على مصدر -أميركي- واحد، نجد أنه بخلاف تميز مقاتلات رافال وفرقطات جويند وفريم وحاملات ميسترال وغيرها من الأسلحة النوعية التي أضافت الكثير للقدرات العسكرية المصرية، أن ذلك انعكس على ازدهار صناعة الأسلحة الفرنسية وازدياد الطلب عليها بعد شراء القاهرة لها، وهو ما جعل هناك حاجة متبادلة لدى حكومتا البلدين في أن يكون هناك مردود جيوسياسي وسياسي لهذه الصفقات لا تقف عند حد التعاون العسكري المشترك ودورية المناورات المشتركة على مختلف الساحات من البحر المتوسط للبحر الأحمر، والتي بلغ متوسط عددها سنوياً 5 مناورات وتدريبات مشتركة.
هذا التأسيس في حالة طائرات رافال كنموذج نجد أنه شمل محددات اقتصادية وسياسية بخلاف تفوقها النوعي على مقاتلات الجيل الرابع (يورو فايتر، إف15، تورنيدو، تايفون، جربين..الخ)، سرعان ما تم تعظيمها على مستوى جيوسياسي، ويمكن حصرها في ثلاث نقاط هي كالتالي:
الأولى: هي أن الطائرة داسو رافال متعددة المهمات، بل يصفها بعض المحللين العسكريين بشاملة المهمات، من القصف والاعتراض والاشتباك والهجوم الجوي والبري والبحري والسيادة الجوية. وهي بذلك تسد ثغرة طالما سعت القوات المسلحة المصرية لسدها منذ مطلع الألفية الجديدة، حيث قِدم طراز الطائرات المتعددة المهمات في سلاح الجو المصري مثل فانتوم4 وميراج 5 وميراج2000، وهي طائرات مداها لا يتناسب مع أخطار متحققة خارج المجال الحيوي للقوات الجوية المصرية.
وحتى مدى طائرات إف 16–مقاتلة اعتراضية بالأساس- لا يصل لمدى أخطار محتملة في غرب ووسط ليبيا أو جنوباً في أثيوبيا، بالإضافة لانتماء كافة الطائرات السابقة للجيل الرابع بما فيها مقاتلات إف 16 الذي تعتزم تل أبيب إخراجها من الخدمة على مدى السنوات الخمس القادمة، وهو ما يلزم القاهرة بمجاراة هذا التفوق الإسرائيلي. بخلاف أن مميزات رافال التسليحية والقتالية ومداها الطويل تناسب تماماً متطلبات تطوير وتحديث القوات البحرية المصرية كذلك مواجهة أي مهمات قتالية مستجدة خارج المحيط الحيوي لمصر.
الثانية: اختيارات التحديث لسد أوجه القُصور السابقة انحسرت بشكل بديهي في المقاتلات الأميركية من طراز إف 15 وإف 18، حيث أن واشنطن هي المورد الأول للأسلحة الجيش المصري طبقاً لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والمساعدات العسكرية الأميركية المنوطة بها، وبالفعل بدأت محادثات بين الجانب المصري والأميركي في 2002 لشراء طائرات إف 15 لتصبح في حال امتلاكها ثالث دولة في المنطقة بعد إسرائيل والسعودية، إلا أن تل أبيب تدخلت لدى الإدارة الأميركية لمنع إتمام الصفقة استناداً لأمرين.
أولهما أن الولايات المتحدة تضمن تفوق إسرائيل العسكري والجوي على باقي دول المنطقة –حصلت إسرائيل على مقاتلات إف 35 عام 2018- وثانيهما أن طائرات إف 15 بعيدة المدى مما يعطي فرصة لكي تتساوى مصر في فرصة ضرب العمق في أي صدام بينها وبين إسرائيل، وهو ما ساقته تل أبيب في معرض اعتراضها على إتمام الصفقة، على اعتبار أن العدو الافتراضي الذي يتدرب عليه الطيارين المصريين هو القوات الإسرائيلية.
وبالتالي تراجعت الإدارة الأميركية عن إتمام الصفقة، وهو ما جعل القيادة السياسية في مصر آنذاك تفكر في بدائل تسد حاجة القوات الجوية إلا أن ذلك كان يعني توتير العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة التي تأسست منذ 1979 على أن واشنطن هي المسئول الحصري لتسليح الجيش المصري، وإبعاده عن أي فرصة للحصول على أسلحة إستراتيجية كالطائرات المقاتلة من روسيا، ولذلك عندما بدأت محادثات بين القاهرة وموسكو عام 2007 لشراء طائرات ميج 29 بدأت أصوات في الكونجرس الأميركي تطالب بتقليص المعونة العسكرية، وهو ما جعل القاهرة تتراجع عن هذه الخطوة، مكتفية بالاتفاق مع واشنطن على صفقة طائرات إف 16 بلوك في 2010.
الثالثة: بمطالعة الدول التي درست شراء رافال قبل مصر، مثل هولندا والبرازيل، وجد أن اختيارات هذه الدول انحسرت في طائرات ميج 29 وسوخوي 32 الروسيتين إف 15 وإف 18 الأميركيتين، وجاس جريبن السويدية وتورنيدو البريطانية ورافال الفرنسية، ووقع اختيارهم حسب احتياجات وظروف كل دولة على الطائرة السويدية، وبالتالي لم تكن رافال هي المقاتلة الأنسب لهم مثلما كانت لمصر لدواعي فنية وسياسية واقتصادية؛ فمن ناحية لم يكن في استطاعة القاهرة أن تقدم على خطوة من شأنها تغيير الحليف الاستراتيجي في واشنطن وخاصة في 2014، واستبداله فوراً بمنافسه الروسي.
فصفقات الأسلحة الإستراتيجية كالطائرات المقاتلة أو الصواريخ الباليستية أو أنظمة الدفاع الجوي المدى والغواصات والسفن وحاملات الطائرات، ليست مجردة ومحصورة في كونها صفقة أسلحة عادية بين دولتين، ولكنها في الغالب تتم وفقاً لعلاقة إستراتيجية بين الطرفين، وبالتالي فأن استبدال واشنطن بموسكو من جانب القاهرة كمورد للأسلحة الإستراتيجية يتطلب إرادة سياسية في عملية استبدال حليف استراتيجي، وذلك كان خيار غير مناسب في وقت سعى فيه الطرفان المصري والأميركي إلى تهدئة أجواء تعكرت بعد الثلاثين من يونيو2013، وهنا كانت فرنسا وطائرات رافال الخيار الأنسب سياسياً، فمن ناحية أكدت القاهرة سياساتها الخاصة بتنويع مصادر التسليح بما فيها الأسلحة الإستراتيجية، ومن ناحية أخرى لم يضع عقبة تعرقل تحسين علاقته بالإدارة الأميركية بشراء أسلحة إستراتيجية من روسيا مثلما فعلت تركيا في صفقة إس 400.
ختام واستشراف
تلخص إجابة السيسي على سؤال عن زيارته قبل الأخيرة لفرنسا عن تعدد أوجه العلاقات بين القاهرة وباريس، وكذلك استمرارية تطويرها وتعميقها وفق محددات استراتيجية وليست مؤقتة مرتهنة غالباً باعتبارات داخلية/انتخابية كالسمت العام للعلاقات الدولية في السنوات القليلة الماضية وخاصة بين دول المنطقة والقوى الكبرى بما فيها واشنطن في عهد ترامب، وأيضاً لن يكون مداها الزمني مرتبط باستثنائية مواجهة تداعيات وباء كورونا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
التوازن الذي أشار إليه السيسي في إجابته له تفسيرات عديدة أقربها التخلص من الاعتمادية الكاملة على واشنطن ومصالحها كسقف لتوجهات مصر الخارجية كما كان الحال في عهد مبارك والتي طغت في مراحلها المتأخرة ، وتعميم الشراكة التي حدثت مع فرنسا على صعيد شرق المتوسط وليبيا على أكثر من محور وملف تتقاطع فيه مصالح البلدين بالنسبة للإقليم، بمعزل عن موقف ساكن البيت الأبيض ومختلف المقاربات والأولويات التي تتحرك وفقها السياسة الخارجية الأميركية ومن يدور في فُلكها بالكامل؛ فمن سد النهضة والقرن الأفريقي إلى الاستقرار في شرق ووسط افريقيا، وخاصة دول جنوب الصحراء كتشاد والنيجر ومالي وقبلهم السودان، وفرت الطفرة الحادثة في العلاقات بين القاهرة وباريس هامش أوسع للتحرك وفق مصالح البلدين سواء تلائم ذلك مع التوجهات الأميركية أم لا.
ويمكن الاستنتاج أنه على الرغم من المكاسب العديدة لتطور العلاقات المصرية الفرنسية على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية، فإن المكسب الأهم هو تحقق السابق بالنسبة لعلاقة كل من البلدين مع واشنطن، وهو ما يتناسب أكثر مع باريس على مستويات أخرى وخاصة مع توليها رئاسة الاتحاد الأوربي، وعلاقة بإعادة هيكلة علاقة دول الاتحاد مع ساكن البيت الأبيض الجديد بعد متغيرات لازالت أثارها مستمرة أقلها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وأحدثها فضيحة التجسس الأميركي على مسؤولين وقادة أوربيين.
وانطلاقاً من السمة الغالبة على الشراكة المصرية الفرنسية، وهي ديمومتها وتعدد مستوياتها، والتي تتأكد بوتيرة متكررة خلال الفترة الأخيرة وخاصة مؤتمر باريس الأخير وما حدث في متنه وهامشه من فاعليات وتصريحات وقرارات أشارت بقوة أن مسألة إعادة هيكلة علاقات ومصالح واشنطن في الإقليم والخارجية بشكل عام لن تكون على حساب مصالح دول فاعلة بحجم مصر وفرنسا، وخاصة إذا كانت هذه المصالح تنطلق من محددات الأمن القومي لمصر على مختلف الاتجاهات في البحر الأحمر والقرن الافريقي وشمال أفريقيا وشرق المتوسط وأخيراً غزة، وهو ما يتقاطع مع مصالح باريس فيما يخص ملفات مثل الهجرة والإرهاب والاستقرار السياسي في مناطق المصالح والنفوذ الفرنسي، والأهم تحييد مخاطر مثل التوظيف السياسي للاجئين والمهاجرين كما دأبت أنقرة في العقد المنصرم.
وكاستشراف، فإن السابق الذي أتى كتطور منطقي لمرتكزات الطفرة التي شهدتها العلاقات بين فرنسا ومصرمنذ 2014، فإنه من المتوقع في المدى القريب أن يستمر نمط تعظيم مكاسب وآليات تطوير هذه الشراكة بكافة محاورها العسكرية والاقتصادية والثقافية والسياسية، والذي كانت بوادره توقيع عقد جديد بتوريد 30 مقاتلة رافال للقاهرة خلال العشر سنوات القادمة.
عن "مركز الإنذار المبكر"


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/lzndny_56_0.jpg.webp?itok=LLzNBHuV)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_3.jpg.webp?itok=yQ6BBSL3)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_0_3_0_0.jpg.webp?itok=sxoX83Qh)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_0_1_3_1.jpg.webp?itok=cVr6G9-Z)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.jpg.webp?itok=L46ObaGI)
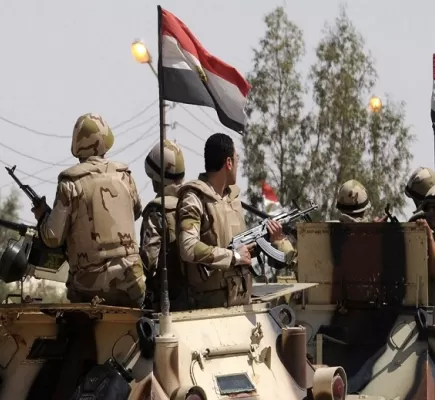
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_5.jpg.webp?itok=-5s4yUMM)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_3.png.webp?itok=m7qfTDwy)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86_1.jpg.webp?itok=_wTQr1NV)















![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/TunisiaTerrorBardoRTR4UMIW.jpg.webp?itok=8qVD2lU1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%87%D8%B1_0_0_0_0.jpg.webp?itok=CX9nsZNg)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/000_33Z33K3.jpg.webp?itok=SDFxi9Av)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_25_1_2_0_1_0_0_1_1_0.jpg.webp?itok=-ojQYLdR)



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%201_0_0_0.png.webp?itok=9YIlS2bv)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7_0_0_0.jpg.webp?itok=UtKFVe22)

